لم يكن المرض طوال تاريخ البشرية، مجرد “خلل” بسيط في الآلة البيولوجية للجسد. لقد كان وما يزال، مرآة تعكس عقلية عصرها وقدراته وتخوفاته. طريقة فهمنا للعلّة تكشف أكثر مما نعتقد: فهي تروي لنا قصة علاقتنا بأجسادنا، بالطبيعة من حولنا، وبحدود قوة العلم نفسه في كل مرحلة.
بتعبير آخر، يمكن قراءة تاريخ الطب كما لو كان تاريخًا لتغير “النظارات” التي نرتديها لنرى المرض من خلالها. كل عصر له نظارته الخاصة التي تحدد له: ما هو المرض؟ وما سببه الحقيقي؟ وما الدليل الذي نصدقه؟ وكيف نتعامل معه؟

وهذه النظارات تتغير جذريًا عبر الزمن:
في الماضي البعيد، سادت نظرة أخلاقية-كونية، حيث كان المرض علامة على اختلال توازن الطبيعة أو حتى عقابًا إلهيًا. ثم جاءت نظرة بيئية، ربطت المرض بـ “الهواء الفاسد” والمياه الملوثة والمكان غير الصحي. فجاءت ثورة البكتيريا والفيروسات في القرن التاسع عشر، لتركز النظارة بدقة على كائن مجهري وحيد كمسبب للمرض.
أما اليوم، فالنظارة أصبحت أكثر تعقيدًا وشمولية. نحن ننظر للمرض كـ شبكة معقدة تتشابك فيها الجينات الوراثية، ونمط الحياة، والضغط النفسي، والبيئة المحيطة، والميكروبات نفسها. لم نعد نبحث عن “السبب الوحيد”، بل عن “خريطة العلاقات” التي تؤدي إلى الإصابة.
هذا التحول في النظرة ليس مجرد تقدم تقني، بل هو قصة تطور فكري، تظهر كيف نعيد باستمرار تعريف معنى أن نكون بشرًا في مواجهة الضعف والشفاء. وهو يذكرنا بأن فهمنا الحالي للمرض، رغم دقته المذهلة، ليس النهاية، بل هو فقط أحدث فصل في قصة طويلة مستمرة.
دعونا نذهب في رحلة مع تاريخ الطب عبر الزمن، من أيام الإغريق حتى عصرنا الحالي:
أولًا: نظرية الأخلاط – التوازن بوصفه مبدأً كونيًا

تُعدّ نظرية الأخلاط (Humoral Theory) من أقدم النماذج الطبية وأكثرها تأثيرًا في تاريخ الطب. تعود جذورها إلى أبقراط (Hippocrates)، الذي حاول فصل الطب عن التفسيرات الأسطورية، ثم طوّرها جالينوس (Galen) في إطار فلسفي متكامل، قبل أن تنتقل إلى الطب الإسلامي الوسيط، حيث بلغت درجة عالية من التنظيم النظري مع ابن سينا (Avicenna).

وفق هذا النموذج، يتكوّن الجسد من أربعة أخلاط أساسية (Four Humors): الدم، والبلغم، والصفراء، والسوداء. الصحة هي حالة توازن (Balance) بين هذه الأخلاط، بينما المرض هو نتيجة اختلال (Imbalance) في نسبها أو خصائصها. لم يكن هذا الاختلال ميكانيكيًا فقط، بل مرتبطًا بالمناخ، والفصول، والغذاء، والانفعالات النفسية، وأنماط السلوك.
في هذا السياق، فُسِّر الاكتئاب، المعروف تاريخيًا باسم (Melancholia)، على أنه زيادة في خلط السوداء، بينما اعتُبرت الحمى فائضًا في الدم أو الصفراء. أما العلاج فكان يهدف إلى إعادة الانسجام عبر تعديل نمط الحياة (Regimen)، باستخدام الحمية، وتنظيم النوم، والرياضة، وأحيانًا الفصد (Phlebotomy).
ورغم أن هذا النموذج يفتقر إلى الأساس التجريبي الحديث، فإنه قدّم رؤية شمولية للجسد بوصفه وحدة متكاملة، ولم يفصل المرض عن التجربة الإنسانية أو السياق البيئي، وهو بعدٌ سيغيب لاحقًا مع صعود النماذج الاختزالية.
ثانيًا: نظرية الميازما – المرض كخلل في البيئة
مع التحولات العمرانية في أوروبا، وتوسّع المدن، وتفاقم الأوبئة في العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، بدأ التركيز ينتقل من الداخل إلى الخارج. ظهرت نظرية الميازما (Miasma Theory)، التي فسّرت المرض بوصفه نتيجة “هواء فاسد” (Foul Air) ينبعث من المستنقعات، والنفايات، والمناطق المكتظة.

مثّلت هذه النظرية خطوة مهمة نحو ربط المرض بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية. فقد أسهم مفكرون ومصلحون مثل إدوين تشادويك (Edwin Chadwick) في إبراز العلاقة بين الفقر، وسوء الصرف الصحي، وانتشار المرض، بينما شددت فلورنس نايتنغيل (Florence Nightingale) على دور التهوية والنظافة في تقليل العدوى داخل المستشفيات.

أمراض مثل الكوليرا والطاعون فُسِّرت ضمن هذا الإطار بوصفها نتيجة تلوث الهواء، قبل أن يُظهر جون سنو (John Snow) أن الكوليرا مرتبطة بتلوث المياه، في خطوة انتقالية كشفت قصور نموذج الميازما، ومهّدت للثورة الجرثومية. ومع ذلك، تركت هذه النظرية إرثًا دائمًا في مجال الصحة العامة وتنظيم المدن.

ثالثًا: النظرية الجرثومية – السببية الدقيقة والانتصار العلمي
أحدثت النظرية الجرثومية للمرض (Germ Theory of Disease) في القرن التاسع عشر قطيعة معرفية حاسمة. بفضل أعمال لويس باستور (Louis Pasteur) وروبرت كوخ (Robert Koch)، أصبح من الممكن ربط مرض محدد بعامل ممرض (Pathogen) محدد، سواء كان بكتيريا أو فيروسًا.

وضع كوخ قواعده الشهيرة لإثبات السببية، مما منح الطب لأول مرة أداة تجريبية صارمة. أدّى ذلك إلى ثورة في اللقاحات (Vaccination)، والمضادات الحيوية (Antibiotics)، والجراحة المعقمة، خصوصًا مع إسهامات جوزيف ليستر (Joseph Lister).

أمراض مثل السل (Tuberculosis) لم تعد لغزًا، بل حالة عدوى ذات مسار معروف. غير أن هذا النجاح الباهر أسّس أيضًا لرؤية اختزالية ترى المرض بوصفه عدوًا خارجيًا يمكن القضاء عليه، وهي رؤية ستواجه تحديات كبيرة مع تغيّر الخريطة المرضية العامة.

رابعًا: النموذج البيوطبي – الجسد كمنظومة ميكانيكية
في القرن العشرين، توسّع منطق السببية الجرثومية ليشمل جميع الأمراض عبر ما يُعرف بالنموذج البيوطبي (Biomedical Model). وفق هذا النموذج، يُفهم المرض بوصفه خللًا في الفيزيولوجيا المرضية (Pathophysiology): طفرة جينية، نقص هرموني، اضطراب كيميائي، أو خلل في عضو محدد.
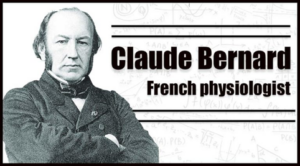
أسهم كلود برنار (Claude Bernard) في ترسيخ الطب التجريبي، بينما مثّل وليم أوسلر (William Osler) نموذج الطبيب الإكلينيكي الذي يربط العلامات السريرية بالأسس العلمية. في هذا السياق، أصبح قصور الغدة الدرقية مسألة نقص هرموني بسيط، وارتفاع ضغط الدم خللًا في تنظيم الأوعية.

غير أن هذا النموذج، رغم دقته ونجاحه العلاجي، افترض ضمنيًا أن كل مرض له سبب واحد يمكن تحديده وعلاجه. ومع صعود الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والاكتئاب، تبيّن أن هذا الافتراض غير كافٍ لتفسير الواقع الإكلينيكي المعقّد.
خامسًا: الطب القائم على الدليل – إعادة تنظيم المعرفة الطبية
في أواخر القرن العشرين، ظهر الطب القائم على الدليل (Evidence-Based Medicine) استجابةً لتفاوت الممارسات الطبية وغياب معايير واضحة للاختيار العلاجي. قاد هذا التوجه باحثون مثل ديفيد ساكيت (David Sackett) وغوردون غايت (Gordon Guyatt)، واعتمد على التجارب العشوائية المحكمة (Randomized Controlled Trials)، والمراجعات المنهجية (Systematic Reviews)، والتحليل التلوي (Meta-analysis).


غيّر هذا الإطار طريقة اتخاذ القرار الطبي، لكنه لم يقدّم تفسيرًا جديدًا لطبيعة المرض، بل ركّز على سؤال الفعالية: أي علاج يعمل بشكل أفضل، ولمن، وتحت أي شروط.
سادسًا: النموذج البيولوجي–النفسي–الاجتماعي – استعادة الكل الإنساني
في سبعينيات القرن العشرين، اقترح جورج إنجل (George Engel) النموذج البيولوجي–النفسي–الاجتماعي (Biopsychosocial Model)، الذي رفض اختزال المرض في المستوى البيولوجي وحده. وفق هذا الإطار، يُفهم المرض بوصفه نتيجة تفاعل معقّد بين العمليات البيولوجية، والحالة النفسية، والسياق الاجتماعي.

في هذا النموذج، يُفسَّر الاكتئاب من خلال تفاعل كيمياء الدماغ مع التوتر والعلاقات الاجتماعية، بينما تُفهم أمراض القلب في ضوء الالتهاب، ونمط الحياة، والضغوط الاقتصادية. وقد أسهم باحثون مثل مايكل مارموت (Michael Marmot) في إبراز دور المحددات الاجتماعية للصحة (Social Determinants of Health).

سابعًا: الطب الدقيق – تفكيك المرض إلى أنماط فردية
مع مشروع الجينوم البشري بقيادة فرانسيس كولينز (Francis Collins)، ظهر مفهوم الطب الدقيق (Precision Medicine)، الذي أعاد تعريف المرض بوصفه بصمة جزيئية فردية. لم يعد السرطان مرضًا واحدًا، بل مجموعة من الاضطرابات تختلف في طفراتها واستجابتها للعلاج.

في سرطان الثدي، مثلًا، تحدد مؤشرات حيوية (Biomarkers) مثل (HER2) أو (BRCA) نوع العلاج الموجّه (Targeted Therapy)، بينما كشف البحث الجيني في السكري عن طيف واسع من الأنماط يتجاوز التقسيم التقليدي إلى نوعين.
ثامنًا: الطب الشبكي – المرض كنظام ناشئ
في العقدين الأخيرين، تطوّر ما يُعرف بالطب الشبكي أو النُظُمي (Network Medicine / Systems Medicine)، المستند إلى علم النظم المعقّدة (Complex Systems). يرى باحثون مثل ألبرت لازلو باراباشي (Albert-László Barabási) ودينيس نوبل (Denis Noble) أن المرض ليس نتيجة سبب واحد، بل خاصية ناشئة (Emergent Property) من شبكة تفاعلات متعددة المستويات.

في هذا الإطار، تُفهم السمنة بوصفها شبكة تضم الهرمونات، والميكروبيوم، والنوم، والسلوك الغذائي، والعوامل الاقتصادية. كما يُفهم الألم المزمن بوصفه تفاعلًا بين الجهاز العصبي، والتجربة النفسية، والسياق الاجتماعي، لا كخلل عصبي معزول.

لماذا لم يعد ممكنًا تقديم تفسير واحد؟
يكشف هذا المسار التاريخي أن كل نموذج طبي وُلد استجابةً لمحدودية سابقيه. لم يُلغِ الطب الحديث نظرية الأخلاط أو الميازما تمامًا، بل تجاوزها بإدخال مستويات تفسير جديدة. اليوم، لم يعد ممكنًا اختزال المرض في جرثومة، أو جين، أو مسار واحد، لأن الواقع المرضي ذاته أصبح أكثر تعقيدًا، ولأن المعرفة العلمية نفسها أصبحت متعددة التخصصات والمستويات.
خاتمة
إن ما يميّز الطب المعاصر، فلسفيًا، هو خروجه من وهم “النظرية الواحدة” الحاكمة. فهو لا يُدار اليوم بواسطة نموذج تفسيري منفرد، بل عبر تعددية نموذجية واعية: النموذج البيوطبي يفسّر الآليات، والنموذج البيولوجي–النفسي–الاجتماعي يوسّع الفهم الإنساني للمرض، والطب القائم على الدليل ينظّم المعرفة العلاجية، والطب الدقيق يعترف بالفردية الجزيئية، بينما يقدّم الطب الشبكي إطارًا نظريًا لربط هذه المستويات داخل منظومات معقّدة. هذه التعددية ليست علامة ضعف معرفي، بل استجابة ضرورية لتعقيد الظاهرة المرضية ذاتها.

وفي هذا السياق، يمكن استحضار مقولة الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار (Gaston Bachelard) بأن «تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء تمّ تصحيحها»، لا بوصفها حكمًا تقليليًا من مراحل العلم السابقة، بل كونها توصيفًا دقيقًا لمنطق تقدّم المعرفة العلمية.
فالطب، كما يظهر عبر انتقاله من نظرية الأخلاط إلى الميازما ثم إلى الجرثومة فالنماذج الشبكية، لم يتقدّم عبر تراكم خطّي للحقائق، بل عبر ما سمّاه باشلار القطيعة الإبستمولوجية (Epistemological Rupture): لحظات يعيد فيها العلم بناء مفاهيمه الأساسية، ويقطع مع بديهياتٍ كانت تُعدّ سابقًا مسلّمات لا تُناقش.
لم تكن الأخلاط مجرّد خرافة أُزيحت، ولا الميازما خطأً عرضيًا، ولا تمثّل النظرية الجرثومية اليوم الحقيقة النهائية، بل كانت جميعها أنظمة تفسيرية عقلانية داخل شروطها التاريخية، بلغت حدودها حين تغيّرت أدوات الرصد، وأسئلة البحث، ومعايير الدليل.
بهذا المعنى، لا يُفهم تطوّر الطب كمسار نحو يقين مطلق، بل كحركة نقد ذاتي مستمرة، يُنتج فيها العلم معرفته عبر تجاوز أخطائه، والوعي بحدود نماذجه، والاستعداد الدائم لإعادة النظر في أسسه كلما اتّسع أفق الفهم وتعقّدت الظاهرة المرضية.

 علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
